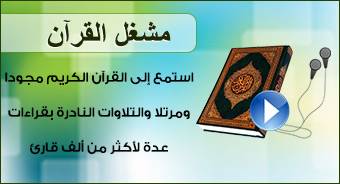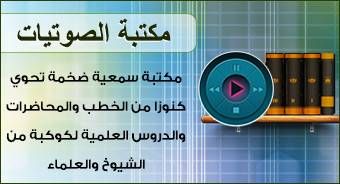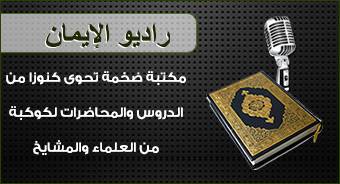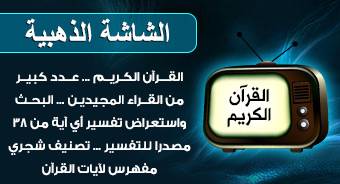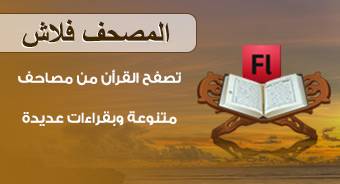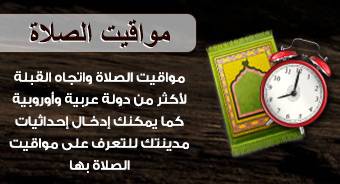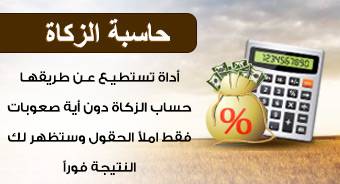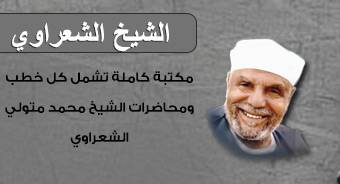|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقنطار مقنطر على المبالغة للتأكيد. وقيل: هو من المال مقدار ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة، وذلك غير محدود القدر في نفسه، وإنما هو بحسب الإضافة كالغنى، فرب إنسان يستغنى بالقليل، وآخر لا يستغنى بالكثير، ومن هنا وقع الاختلاف في حده. [الكليات ص 733، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250].
وقنت: دعا وأطال الدعاء. والقنوت: هو الطاعة والدعاء والقيام والخشوع، والمشهور هو الدعاء. وقولهم: (دعاء القنوت): إضافة بيان، وهو: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وتنوب إليك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونركع ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق». [البيهقي 2/ 210]. والمعنى في الدعاء: أي يا الله نطلب منك العون على الطاعة وترك المعصية، ونطلب المغفرة للذنوب ونثنى من الثناء وهو المدح، وانتصاب الخير على المصدر، والكفر: نقيض الشكر، وقولهم: كفرت فلانا على حذف المضاف، والأصل كفرت نعمته ونخلع من خلع الفرس وسنه إذا ألقاه وطرحه والفعلان موجهان إلى (من) والعمل منهما نترك ويفجرك: يعصيك فيخالفك. والقانت: هو القائم بالطاعة الدائم عليها. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 70، وتحرير التنبيه ص 132، وأنيس الفقهاء ص 96، ودستور العلماء 3/ 52، والكليات ص 702، والمطلع ص 89، ونيل الأوطار 2/ 341، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 134].
قال الجوهري: يقال: قنوة الغنم وغيرها، قنوة وقنوة بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضا قنية وقنية- بالكسر والضم-: إذا اتخذتها لنفسك لا لتجارة وما قنيان وقنيان بالضم والكسر، يتخذ قنية، وقنيت الجارية بالضم على ما لم يسمّ فاعله تقنى قنية إذا سترت ومنعت اللعب مع الصبيان. - وهي بمعنى الكسبة، وأقنيته: كسبته، واتخذته لنفسي قنية لا للتجارة. - وتأتى بمعنى الإمساك، وفي (الزاهر): القنية: المال الذي يؤسله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله. - والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ للتجارة وما يتخذ للقنية، فالقنية تعطيل المال عن الإنماء. [تحرير التنبيه ص 132، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 158، 303، والموسوعة الفقهية 7/ 64].
- وقهقهة في صلاة لمصلّ بالغ عمدا أو ناسيا ناقضة للوضوء عند الحنفية وهذا على خلاف القياس، لأنها ليست بنجس حتى يكون خروجها ناقضا، ولهذا لا يقول غيرهم بنقضها. [دستور العلماء 3/ 104، والموسوعة الفقهية 28/ 174].
وعرفا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: هي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها. [المصباح المنير (قدح) ص 491 (علمية)، وغاية الوصول ص 127].
[شرح الكوكب المنير 1/ 30].
وقاته يقوته قوتا بالفتح وقياتة، والاسم: القوت بالضم، وما عنده قوت ليلة وقيت ليلة، وقيته ليلة- بكسر القاف فيهما-، وقتّ زيدا فاقتات، واستقاته: سأله القوت، وهو يتقوت بكذا. [المصباح المنير (قوت) ص 518 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 135].
وسمى القود قودا، لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاءوا. [المعجم الوسيط (قود) 2/ 795، والمصباح المنير (قود) ص 518، 519 (علمية)، والمطلع ص 357].
وقوله تعالى: {فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ} [سورة النجم: الآية 9]: تعبير يدل على القرب: أي كان الملك والرسول في قربهما واتحادهما مثل قاب واحد لقوسين متجاورين، أو على القلب كما مر: أي مثل قابى قوس واحدة، والتعبير مأخوذ من عادات العرب القديمة، وهو عند العلماء مثل يضرب للقرب عند اللقاء والمقابلة. قال الجوهري: من أنّت؟ قال في تصغيرها: قويسة، ومن ذكّر قال: قويس، والجمع: قسى، وأقواس، وقياس، وهي (فارسية وعربية). والقوس العربي: هو قوس النبل. والقوس الفارسي: هو قوس النشاب، قاله الأزهري. [المصباح المنير (قوس) ص 519 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 96، والمطلع ص 268].
وأصله بالفارسية: جلة، وهي كبّة غزل، والكثير جلهاء، وبها سمي الحائك. [النظم المستعذب 2/ 101].
[الكليات ص 735].
- وقد يكون القول بمعنى الظن، جاء في (غريب الحديث) للبستي: قوله: (أتقوله) يريد: أتظنه، قال الشاعر: أي: متى تظن القلص تلحقهما، ولذلك نصب القلص. - وقال في نفسه: أي أدار الكلام والمعاني في ضميره ولم ينطق به، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِما نَقُولُ} [سورة المجادلة: الآية 8] وقد كشف الله عن هذا الحديث النفسي وأعلم به رسوله صلّى الله عليه وسلم. وجاء في (الموجز في أصول الفقه): أن القول هو اللفظ المستعمل. والصلة بين القول والعبارة: أن القول أعم من العبارة، لأن العبارة تكون دالة على معنى. [غريب الحديث للبستي 1/ 335، والموجز في أصول الفقه ص 97، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 137، 138، 139، والموسوعة الفقهية 29/ 262].
فائدة: كل قول في القرآن مقرون بأفواه وبالسنة فهو: زور. [المفردات ص 217، والكليات ص 702].
ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالا ونساء، مثل: قوم نوح، وقوم إبراهيم- عليهما السلام-، واستعمل مضافا إلى ياء المتكلم، وأثبتت ياء المتكلم في خمسة مواضع، منها: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [سورة الأعراف: الآية 142]، وقوله تعالى: {يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ} [سورة يس: الآية 26] وكلها لغير النداء، وحذفت ياء المتكلم مع النداء في 47 موضعا، مثل قوله تعالى: {يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 54]، وقوله تعالى: {وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} [سورة هود: الآية 52]. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 144].
ويقال: (قاس الجراحة بالميل): إذا قدر عمقها به، ولهذا سمى الميل مقياسا وسيارا، ويأتي بمعنى التشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب إذا كان بينهما مشابهة في الصورة والرقعة أو القيمة، ويقال: هذه المسألة قياس على تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة. واصطلاحا:- جاء في (أحكام الفصول): القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما. - وفي (منتهى الوصول): مساواة فرع لأصل في علة حكمه. - وفي (لب الأصول): حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. - وفي (غاية الوصول): حمل معلوم على معلوم، بمعنى متصور، أي إلحاقه به في حكمه (لمساواته) له (في علة حكمه) بأن توجد بتمامها في المحمول (عند الحامل). - وفي (الحدود الأنيقة): حمل مجهول على معلوم لمساواته له في عليّة حكمه. - وفي (التعريفات): عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. - وفي (الواضح) للأشقر: طريقة في الاستدلال هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم فيلحق الأمر المسكوت في الشرع على حكمه بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشتركا في علة الحكم. قياس الأولى: قيل: القياس الأولى هو الجلي، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم. القياس الجلي: نقيض الخفي، وجلوت الشيء: أظهرته بعد خفائه، ولهذا سمى الصّبح: ابن جلاء، لأنه يجلو الأشخاص ويظهرها من ظلم الليل. وهو الذي تعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما أو يبعد، كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السمن من المائعات والجامدات عليه، وقياس الغائط على البول في الماء الرّاكد. وهو ما عرفت علته بالنص، أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر، وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله لا تنقص عنه، كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه. القياس الخفي: ما احتاج إلى نظر في استدلال، أو كان في التعليل أمر خفي، أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، كقياس الذرة على القمح، وقياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. قياس المساواة: هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: (أ) مساو لـ (ب)، و(ب) مساو لـ (ج) فـ (أ) مساو لـ (ج) إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق في قولنا: (أ) نصف لـ (ب)، و(ب) نصف لـ (ج) فلا يصدق (أ) نصف لـ (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع. القياس العقلي: هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل. القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم. ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس. القياس الاقترانى: نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل. فائدة: الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، وهذا هو القياس. ويكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص بمعرفة درجاتها من حيث القبول والرد، وبمعرفة دلالات تلك النصوص، ومعرفة الأحكام من أدلتها الأخرى غير القياس من قول صحابي أو عمل أهل المدينة أو الاستصحاب أو الاستصلاح أو غيرها عند من يقول بها. وعند المنطقيين: القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلم يلزم لذاته قول آخر. اعلم أن المراد بالقول الأول المركب ملفوظا أو معقولا، والقول الثاني مختص بالمعقول إذ لا يجب تلفظ المدلول من تلفظ الدليل ولا من تعقله والمؤلف لكونه من الألفة أعم من المركب بعدم اعتبار الألفة والمناسبة بين أجزائه، ففي ذكر المؤلف بعد القول إشارة إلى أن التأليف معتبر في القياس دون التركيب مطلقا، وإن كان جنسا له على أنه لو قيل القياس قول من قضايا لما تعلق من قضايا بالقول لأنه بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد كما مر في القول فلابد من ذكر المؤلف بعد ليصح التعلق، وأيضا لو لم يذكر لتوهم أن كلمة من للتبعيض فلا يكون تعريف القياس مانعا لصدقه على قضية مستلزمة لعكسها المستوي وعكس النقيض. فإن قلت: إن القول لما كان أعم فيكون تعريف القياس شاملا للملفوظ والمعقول، فالاستلزام ممنوع، فإن تلفظ الدليل لا يستلزم بالمدلول: أي المطلوب (قلنا) إذا أريد بالقول الملفوظ فالمراد بالاستلزام الاستلزام عند العالم بالوضع. فمعنى التعريف المذكور: أنه كلما تلفظ العالم بالوضع لزمه العلم بمطلوب جزئي، فالاستلزام ليس إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، وهو لا يضرنا إذ لا يدعى الكلية. - واعلم أن القياس لا يتألف إلا من مقدمتين، أما المقدمات فقياسات محصلة لقياس ينتج المطلوب، فإن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وإلا فمفصولة النتائج. [دستور العلماء 3/ 106، 107، والتوقيف ص 595، والنظم المستعذب 2/ 353، وتحرير التنبيه ص 362، والتعريفات ص 160، وميزان الأصول ص 550، وشرح جمع الجوامع للمحلي 2/ 240، والكليات ص 713، والواضح في أصول الفقه ص 240، والموسوعة الفقهية 1/ 317]. |